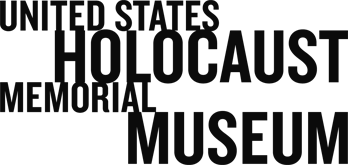8 يوليو 2013
عومر بوم:
لا تكمّن الفكرة في محاولة التعرّف على نظرة المسلمين للعلاقات التي تربط اليهود والمسلمين منذ أوائل عام 1900 فحسب، بل إنها أيضاً تشمل معرفة ما نظرية المسلمون لليهود في الوقت الحاضر.
أليسا فيشمان:
عاد الأستاذ عومر بوم إلى مسقط رأسه في المغرب لدراسة الاتجاه المتزايد نحو معاداة السامية. لذا فقد أجرى مقابلات شخصية مع مواطنين مغاربة مسلمين ينتمون إلى أربعة أجيال مختلفة، رغبةً في التعرّف على ما يشعرون به تجاه اليهود. وكان ما توصّل إليه عومر هو تحوّل ملحوظ نحو تراجع معدلات التفاعل معهم وكذلك زيادة العدائية تجاههم. ونظراً لتقلص أعداد اليهود في المغرب، والحد من تدريس تاريخ اليهود وثقافتهم في المدارس، فإن العديد من الشباب يستقون معرفتهم عن اليهود من خلال كتابي "كفاحي" و"بروتوكولات حكماء صهيون" المعروف بمعاداته للسامية والذي يتم تداوله على نطاق واسع.
مرحبًا بكم في "آراء حول معاداة السامية"، وهي حلقات لنشرة صوتية يتم بثها عبر الإنترنت، مأخوذة من المتحف التذكاري للهولوكوست في الولايات المتحدة، والتي خرجت إلى النور بفضل الدعم السخي "لمؤسسة إليزابيث وأوليفر ستانتون". معكم أليسا فيشمان. إننا نقوم بدعوة ضيف شهرياً للتحدث حول الطرق العديدة التي تؤثر بها معاداة السامية والكراهية على عالمنا اليوم. ومعنا هذا الشهر عومر بوم، الأستاذ في علم الأنثربولوجيا.
عومر بوم:
لقد أجريت دراستي على منطقة الجنوب، وهي مناطق ريفية كانت تضم ما بين 10,000 إلى 20,000 يهودي، لكنها الآن خالية منهم تماماً. لكن لا يزال يوجد بعض الأمور التي تذكرنا باليهود الذين كانوا يعيشون بتلك المناطق يوماً ما، حيث يوجد الأحياء والمعابد والمدافن اليهودية. وتؤكد كل هذه الشواهد على إقامة مجتمع يهودي هناك يوماً ما، واليوم يخلو المكان تماماً من أي يهودي. ولنرى الآن كيف يتعامل المسلمون مع هذا الغياب؟ أي لنرى ما تبقى من ذكريات المسلمين عن غياب اليهود. وتحول الذكريات المتعلقة بالغياب من ذكرى تنم عن علم إلى مجرد صور نمطية ومعاداة لليهود والكشف عن العنصرية.
فهذا المكان يمثل أحد أقدم المجتمعات اليهودية في العالم العربي، كما إنه يمثل إحدى أغني الحضارات التي تضرب مثلاً في التكافل والتعايش التاريخي بين اليهود والمغاربة. فلا شك أن كل منهما كان له تأثيره على الآخر. فقد تشاركا في لغةٍ واحدة، وطعاماً واحداً، وكانت لهما نفس الرقصات. وهذا ما قصّه عليّ كل من ينتمي إلى الأجيال السابقة. فعلى حد قولهم: "لم يكن أمامنا حلٌ سوى التعايش؛ لأننا كنّا نُعاني من النقص في كل شيء. فقد تحتّم علينا مشاركة المياه. كان كلانا في مركب واحد." لذا يُمكنك معرفة الكثير من الأجيال السابقة عن اليهود من الباعة الجائلين أو العائلات اليهودية، الذين قدّموا يد العون للمسلمين في أوقات الجفاف. وبهذا يُمكنك أن تلاحظ أن الكثير ممن ينتمون إلى الأجيال السابقة يؤكدون على فكرة أن "اليهود كانوا متعاونين". الأمر الذي لا يُمكن أن تجده بين الأجيال الأصغر سناً. فلن تجد في قاموسهم كلمة "متعاون" سوى على نطاق ضيق جداً ومحدود. فالأمر بالنسبة للأجيال الأصغر سناً مختلف تماماً: اليهود شعب قوي. وتعكس هذه العبارة التأثير العميق لكتاب "البرتوكولات"، والذي تمت صياغته في ضوء الصراع العربي الإسرائيلي.
فإذا تطرق الحديث مع أبي وأمي إلى اليهود، كانا يذكران لي أسماء أشخاص بعيّنهم. كانا يعرفونهم بالاسم. ويذكرون ما فعله اليهود آنذاك. ويعرفون زواجتهم، بل وأطفالهم. فقد كانوا يعاملونهم كأشخاص مختلفين من حيث المعتقدات الدينية، لكن لم يعاملوهم كدخلاء قط.
وعندما شبّ عودي، لم تتح لي فرصة مقابلة أي يهودي سوى في مراكش عام 1981، في الوقت الذي نترك فيه المدرسة، وكان أول شيء قُمت به هو البحث عن اليهود الذي يغادرون "الأليانس"، وهي المدرسة المخصصة لليهود آنذاك، والذهاب إليهم وضربهم. والحق إنني لست فخوراً بما فعلت، لكنني في الوقت نفسه لا أخجل من قول ما حدث، لأن المجتمع يفرض على الأطفال فعل أشياء معيّنة. فهي مسألة تتعلق بالتربية، والتجارب الاجتماعية. لكن بالكاد تسمح المدارس المغربية بدراسة ثقافة اليهود وتاريخهم. وهو أقل القليل. وبالطبع فإنك تجد الشباب يكتفون بما يتحصلون عليه من الإنترنت، دون الاحتكاك عن كثب بالعلاقات بين اليهود والمسلمين. لذا أراهنك على أن العشرين شاباً الذين تحدثت إليهم، لم يسبق لهم أبداً مقابلة أي فرد يهودي.
كان والدي عاملاً في معظم حياته. فإنه لم يمتلك يوماً ما أرضاً أو عقاراً. وكان كلا والدي أمييّن، ولم يسبق لأي منهما أن ذهب إلى مدرسة قط. وأغلب الظن أنهما لا يعيان الجزء النظري من دراستي، لكنهم على دراية بموضوع الدراسة الذي يدور حول اليهود، إلا إنهم لا يرون في ذلك أي مشكلة. وعلى العكس، فهم فخورون بي كأي مغربي قادم من أقاصي البلد، وكأي من حاملي درجة الدكتوراة في مقاطعتي الذين يُمكن إحصائهم على أصابع اليد. والجانب المشرق في الأمر هو أنني لست الشخص الوحيد الذي يُجري مثل هذه الأبحاث. فالعديد من أبناء وطني يطرحون مثل هذه الأسئلة. وبطبيعة الحال فإن نصيب الأسد يذهب إلى الصراع العربي الإسرائيلي، الذي يتغافل عنه الكثيرون عن عمد. لكنني لا أخشَ أي تهديدات، لأنك إذا قررت أن تنضم لغمرة المفكرين، فعليك أن تتفاني في التفكير في الاستفسارات المعقدة التي تدور في بيئتك الاجتماعية ومجتمعك، وهذه بالضبط هي مهمتي.
ويُمكنك أن تستعين بمثل هذه الدراسة، لتُطبقها على أي مجموعة أخرى. فعلى سبيل المثال يُمكنك تطبيقها أيضاً لمعرفة كيف يُفكر الأمريكان من أصل إفريقي في الأمريكان البيض. كذلك يُمكنك تطبيق الدراسة نفسها بالعكس، أي لترى كيف يفكر الأمريكان البيض في الأمريكان من أصل إفريقي، وهي مسألة تتعلق باختلاف الأجيال. ولا شك أنك ستتعلم الكثير من خلال ملاحظة هذه التحوّلات، لأنها تُملي علينا كمجتمع ما يُمكن فعله لضمان أن يعي أطفالنا والأجيال المستقبلية أهمية احترام الآخرين. فهذه هي مهمة المجتمع، إذ يلزم عليه تتبع الأسباب التي أدت لمثل هذه التغيُرات، ثم العمل على تصحيحها. وذلك لأن معيار تقييم الشعوب هو قياس قدر احترامهم للاختلاف، وما يكنون من احترام للأقليات.